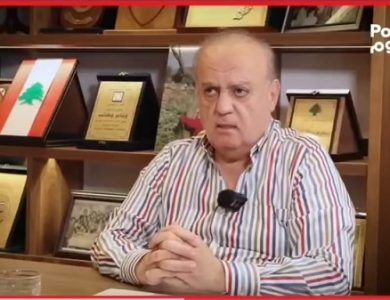عن مؤتمر تل أبيب ووهم إنقاذ الأقليات: حين يتحول الدفاع عن التنوع إلى مشروع تفتيت!!!
كتب د.بسام أبو عبد الله

في الوقت الذي ما تزال فيه الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تُوثَّق يوميًا، وتُصنَّف دوليًا على أنها جرائم حرب وإبادة جماعية، يخرج علينا مؤتمر في تل أبيب يتحدث باسم الأقليات في سورية، وكأن من غاص في دماء الأبرياء يمكن أن يمنح دروسًا في حماية التنوع! المفارقة هنا ليست سياسية فحسب، بل أخلاقية ومعرفية أيضًا. فكيف يمكن لمن أقرّ قانون “قومية الدولة” عام 2018، الذي حوّل إسرائيل إلى دولة يهودية تُقصي كل من هو غير يهودي وتجعله مواطنًا من الدرجة الثانية، أن يتحدث عن المساواة والعدالة وحقوق الأقليات؟
أولًا، إنّ قانون “القومية” لم يكن مجرد تشريع عابر، بل لحظة فاصلة أنهت رسميًا صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية كانت تُقدَّم للعالم الغربي، وأعلنت بوضوح أنّ “الدولة لليهود فقط”. بهذا المعنى، لا يمكن لدولة قامت على التمييز البنيوي والعنصري، أن تتحوّل فجأة إلى راعٍ للتعددية في بلد آخر. كيف يستوي أن تُقصي من يعيش على أرضك، ثم تزعم الدفاع عن غيرك باسم “حقوق الإنسان”؟
ثانيًا، أرفض تمامًا مفهوم “الأقليات”، وسبق أن كتبت كثيرًا حول هذا المصطلح الاستعماري الذي أُدخل إلى وعينا عبر منظومات فكرية وسياسية غربية. فالمسألة ليست في العدد، بل في طبيعة الانتماء الوطني. هذا المفهوم كان أداةً استعمارية لتقسيم المجتمعات من الداخل، وتحويل التنوع إلى خطوط تماس. ومع ذلك، لا يعفينا هذا الرفض من نقد الذات، فنحن أيضًا ساهمنا تاريخيًا وثقافيًا في إعادة إنتاج هذه البُنى الإقصائية من خلال خطاب ديني أو اجتماعي تمييزي ساهم في تكريس الفوارق بين أبناء الوطن الواحد.
ثالثًا، من الطبيعي تمامًا أن يبحث الإنسان عن الأمان حين يشعر بأن وجوده مهدد. لا يمكن التنظير على من يُذبح أو يُهجّر أو يُعدم في الشوارع. كل الشعوب، حين تواجه خطرًا وجوديًا، تلجأ إلى من تظن أنه سيحميها، وهذا مفهوم من حيث الغريزة الإنسانية. لكن المشكلة تبدأ حين يتحول هذا الخوف المشروع إلى بوابة لتسليم القرار الوطني إلى الخارج، وتبرير الاصطفاف خلف قوى تملك مشروعًا واضحًا لتفكيك الدولة والمجتمع.
رابعًا، مع كل الألم الذي حملته السنوات الماضية لمختلف المكونات السورية، تبقى طريقة العمل الصحيّة محصورة في الإطار الوطني الجامع. هناك اليوم عقلاء كثر من كل الأطياف يعملون بصمت وإخلاص في مواجهة ما يمكن تسميته “الفاشية الدينية المتوحشة”، تلك التي بدأت بمجازرها ضد العلويين والدروز والمسيحيين، لكنها لن تتوقف هناك. فهذه الفاشية لا تقبل إلا من هو من طينتها، وستلتهم الجميع، سنةً وشيعةً، عربًا وكردًا، لأن جوهرها يقوم على الإلغاء التام للآخر.
خامسًا، استمرار هذه الفاشية الدينية بحد ذاته هو استمرار لوصفة التقسيم والتفتيت، حتى لو ادعى أصحابها حرصهم على وحدة سورية. فكل خطاب يُقيم الشرعية على الهوية الطائفية أو المذهبية هو وقود لمشروع الانقسام، مهما تجمّل بالشعارات الوطنية. الأفعال على الأرض تكذب الأقوال، والتاريخ لا يرحم من يساهم – عن قصد أو عن جهل – في تفكيك النسيج السوري.
سادسًا، لا ينبغي أن نفاجأ بسلوك السوريين في ظل ما مرّوا به. فالوعي الجمعي للشعوب لا يُصنع في لحظة، بل هو حصيلة طويلة من التراكمات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. عندما يتعرض المجتمع لصدمات متتالية، يتراجع وعيه من الجماعي إلى الغريزي، ويبحث الفرد عن فرص النجاة الذاتية. لذلك فإن إعادة بناء الوعي الوطني تحتاج إلى مشروع تربوي وثقافي شامل، يعيد للإنسان السوري ثقته بنفسه أولًا، وبوطنه ثانيًا، وبالمشترك الإنساني الجامع ثالثًا.
سابعًا، السلام الحقيقي الذي نريده في المنطقة ليس سلام الخضوع، ولا سلام بيع الحقوق وتقسيمنا إلى ملل وطوائف متناحرة. السلام العادل هو الذي يقوم على الاعتراف المتبادل، وعلى العدالة والمساواة، لا على الإكراه والإخضاع. فحين تكون أنياب المشروع بارزة، لا يجوز أن ننخدع بابتسامته.
الخاتمة:
نحن لسنا ضد اليهود، ولا ضد أي ديانة أو مكوّن بشري. عداؤنا ليس دينيًا بل مبدئيًا مع الفاشية أيًا كان لبوسها: دينية كانت أو قومية، يهودية أو إسلامية. ما نواجهه اليوم هو صراع بين من يريد للإنسان أن يكون حرًّا، وبين من يريد له أن يكون تابعًا. والخلاص، كما أؤمن وأكرّر، لن يكون في تل أبيب ولا في أي عاصمة أخرى، بل في مشروع وطني سوري جامع، يُعيد للناس ثقتهم بذاتهم، ويجعل من تنوعهم مصدر قوة لا بابًا للفتنة والانقسام.